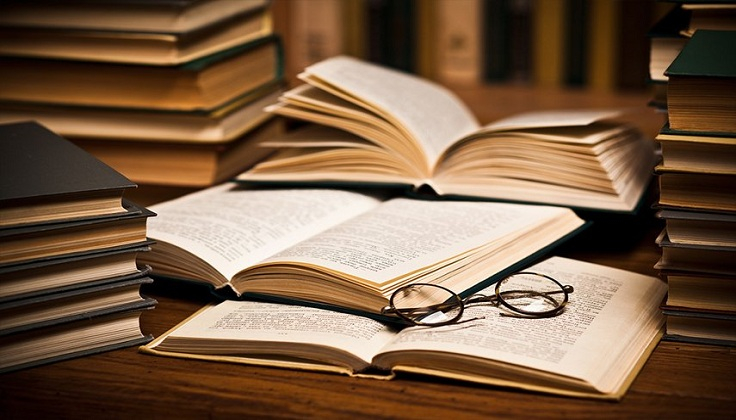لا نشك بوجود مثل هذا القارئ، لكننا نشك بطريقة القسْر على أن تكون مهمته بلاغية صارمة في تفكيك آليات النص. بمعنى أن هذه النظرية النقدية الإجرائية تنبثق من خيارين: الأول اختيار قارئ أنموذجي متطور وليس قارئاً عابراً، يكون أعلى من مستوى النص والمؤلف. والثاني: تحييد المؤلف ومنح سلطة تفيد بأن بلاغة القارئ توازي أو تتقدم على بلاغة النص الى حد كبير. في هذا الفرْض القسري نجد في النظرية انحرافات منهجية تنشغل بعيداً عن النص وآلياته الإبداعية المتعددة، وربما انحرافاً جوهرياً عن المعنى الدلالي للنصوص السردية على وجه الخصوص، لو نظرنا الى عدّ المكوّن الشعري كمجموعة صورية لغوية يصعب فرزها الى عناصر حَدثية، بقدر ما هي صور متعاقبة والهامات فيضية متدفقة؛ بينما السرديات هي آليات وبنيات لغوية وثيمات متعاقبة، وصور حدثية متحركة، تتعاقب أو تعود الى ماضي النص أو تستقرئ مستقبل الشخصيات فيه، أو تعتمد مرجعيات متعددة، فولكلورية. شعبية. تاريخية. علمية. جغرافية. واقعياً؛ فأنّ الكيان الغائب أثناء الكتابة هو القارئ، والكيان الحاضر هو الكاتب/ المؤلف الذي يُزجي أوقاتاً طويلة في التأمل والتدبّر ومطاردة الأفكار، ومن ثم التحبير وممارسة إعادة الكتابة مراتٍ كثيرة في مهارات عصبية لا نراها في الأغلب الأعم، وهذا يعني إحكام سلطتَي اللغة والخيال فيه، وهما برأينا عِماد الكتابة. لكنْ هناك قارئ له فاعلية احترافية، يدرك أن وراء كل عمل أدبي عقلاً لغوياً مدبراً، فإذا كانت اللغة وسيلة جبرية لصياغة الأطر المعرفية، فأنها أيضاً تستعين بالعلامات والإشارات والرموز المعرفية - الجمالية لصياغة الأثر في مضمونه الشخصي، أحياناً تملأ النص بوجود فاعل، وهذه معرفة ليست جديدة في الدلالات والإيحاءات، بل هي أطر متجدّدة مع النسق الثقافي العام؛ وبالتالي فأن نظرية مثل التي قدمها ميشيل شارل تتطلب إيجاد قارئ بفهمٍ خاص/ متطور، نوعي، أنموذجي، غير خاضع للنص/ بشروطه التأليفية لو كانت هناك شروط ، انما تفكيك آلياته على وفق منهجه النظري الذي نراه صعباً ومشروطاً، يقدّم فيه القارئ- الناقد، على القارئ- الاعتباري الذي تتوجه السرديات اليه بشكل دائم.
وهذا ما يذهب اليه امبرتو إيكو بوصفه أنّ "فاعلية القارئ" المقبل من ذاكرة ثقافية، لكن عدّهُ قارئاً مفترضاً، وليس عاملاً أخيراً في تفكيك النص الى الحد الذي يكون فيه بديلاً عن المؤلف والنص معاً. أو القول لإثبات موت المؤلف عند البنيوي رولان بارت، وتجريده من صفاته الاعتبارية المؤسِّسَة لكيان النص.
إن آليات النصوص السردية عموماً وبنياتها اللغوية تعمل على وفق شكلين: داخلي وخارجي، وكلاهما ينسجان معرفة إطارية، لإيجاد الشكل المناسب للنص الإبداعي. هو تشكيل بانوراميّ لصور مرئية في تضاعيف النص المُختلَق؛ روايةً وقصةً، وهنا يمكن تشبيه الإطار بالمرآة الحافظة لها من الغبار والخدوش من كل اتجاه، لذلك نرى أن السرديات الروائية أضحت شكلاً مبدعاً على حساب الثيمة وشكلاً من أشكال الإبداع، فالمعنى الجاحظي المعروف (المعاني مطروحة في الطريق- نسبة إلى الجاحظ) ما عاد هو المقياس البارومتري للعمل الأدبي، إذْ تقدم الشكل على منهج الثيمات التي كان المؤلفون يبحثون عنها، والشكل الفني لا يمكن لأي قارئ تطوري وأنموذجي أن يقرر استقباله من عدمه، قبوله أو رفضه، فهو من ابتكار المؤلف وصنيعته الإبداعية، لهذا نرى أن مثل هذه النظرية افتراضية الى حد كبير، ونحسبها كما لو أنها ضد القراءة المنتجة والفاعلة، وهو أمر يحيلنا الى "موت المؤلف" عند البنيوي رولان بارت الذي وجد في المؤلف صيغة زائدة على النص، ومنح القارئ منصة محاكمة له. ولما كان القارئ يستقبل مثل هذه الدعوات النقدية، فمن اليقين أن له حدوداً، فهو ليس ملهِماً في الأحوال كلها، إنما هو فاعلٌ في حدوده القرائية الزمنية، ولا يمكن له أن يستقرئ صيغ الإبداع في المستقبل الذي تتطور أشكاله ولغته وضبطه الفني وأشكاله الجديدة التي عبرت الزمن والثقافات العامة. وعليه فأننا نرى كل شكل مناسب هو إطار يتوجب فيه حماية جوهر النص من أضرار متوقعة، قد نحسبها عند قارئ ذكي أو ناقد متفحص يفتح شريان الكتابة، فالشكل الأدبي، هو إطار فني ماسك للمتن السردي والموضوعة الشخصية للكتابة، عبر بنيات اللغة وآلياتها الواعية، ونرى بأنها المعنية بالمعنى ودلالاته الاصطلاحية والإجرائية والمختبرية.في الوقت الذي نجد فيه القصيدة المكثفة ذات صور متدفقة، وهي شكلها أيضاً (رأي شخصي: القصيدة لا شكلَ لها، باعتبار أنها شكلها) نلاحظ أن الرواية تخضع الى شكلين في محيطها: خارجي وداخلي؛ إطار داخل إطار، بتعامد قد يكون مرئياً وقد يكون قناعاً وتمويهاً لحدث أو أحداث تجري في نسق الكتابة ومهيمنات الإجراءات السردية فيها. كل الأطر الأدبية هي من اختراع اللغة وإشاراتها وعلاماتها، وقدرتها على التشكيل في رسم الصورة الأخيرة لأي عمل إبداعي ومن كل جنس أدبي. لكن هذا لا يعني أن المهارة الشخصية للكاتب تظل خارج النص الأدبي؛ بل أن مكونات الاتصال اللمّاحة التي هي مثل الخيط المرئي بين القارئ الغائب المجهول، وبين الكاتب والكتابة، تتطلب مثل هذا الاتصال الشبحي قبل أن يكون حقيقياً، لذلك فالقوة اللغوية وحدها هي التي تتمكن من ضبط إيقاع السرديات وتوجيه أسرارها الى قرّاء مختلفي الثقافات والتلقي والإصغاء الى صوت الكتابة. وسنجد القارئ الغائب/ المتواري/ المجهول/ بتعددية مصادره الثقافية والجمالية، هو الآخر يتماهى مع الكتابة بطريقة قد لا تخطر على بال الكاتب، لكنه ليس بديلاً عنه. وليس وجوده الفوقي مهماً بالنتيجة، فالقراءة عادة ثقافية موصوفة بالجمال والمشاركة الضمنية مع المؤلف.
ربما أوجدت نظريات التلقي بأشكالها الكثيرة، أكثر من فسحة للقارئ بمسمياته المتعددة، منها ما حَكم بموت المؤلف، وهذا إجراء بارتي بنيوي جدلي غير حاسم. وبينما يقول سارتر أن الأدب "كيان معطل" يتحقق وجوده بفعل القراءة. تتشكل عند رومان أنغاردن صيغة نقدية يرى فيها أن السرود كلها لا يمكن لها أن تتحقق "إلا بعد قراءتها" بما يعطي للقارئ دوراً مركزياً في ملء ثغراتها ونواقصها.
وهذه فرضية تتطلب نوعاً غير اعتيادي من القراءة الفاحصة والمتمكنة، التي تتآخى مع النص وتغور في تضاعيفه، بما يسمح لها أن تكون منتجة وفاعلة داخل المتن السردي. بينما تركز النظرية السيميائية على النصوص من دون الرجوع للسياق التأليفي، على اساس أن "البنيات المغلقة" تتطلب قارئاً حاذقاً؛ متفقة الى حد ما مع نظرية ميشيل شارل، وهو إجراء ليس مضموناً على أية حال.في حصيلة إجمالية تقضي بأن المسرودات كلها تنتهي من حيث يبدأ القارئ بقراءتها. كمعطىً لجماليات القراءة ما بعد البنيوية، إذ يتمخض عن ذلك إنتاج جدلي وليس استهلاكاً كما درجت قراءات ما قبل البنيوية، من دون اتفاق على أن القراءة (تبدأ) من حيث (بدأ) القارئ، على أن تبقى اللغة هي معيار الكتابة وأساسها المتجوهر في عملية العطاء والخلق والتجديد، وهذا ما يساهم به القارئ غير المعروف، وتصنيفاته التي وضعتها نظريات وآراء المحدثين من النقاد وباحثي الأدب البنيويين وما بعدهم في حداثة الإجراءات النظرية التي سادت كثيراً كمفاهيم أدبية يتدرّع النقد بها، ويحاكم المسرودات على أنواعها بواقع تلك النظريات.
امبرتو إيكو يقترح القارئ الأنموذجي.
القارئ الخبير من اقتراح ستانلي فيش.
القارئ الجامع عند ميخائيل ريفاتير
والقارئ الضمني عند آيزر.. وتستمر سلسلة التصنيفات النقدية التي اكتسحت عوالم السرد بآلياته ومصنفاته في تعدد نوعيات القارئ: التاريخي - الخيالي-المثالي- الملتزم- الافتراضي- المركّب- الثقافي- النفسي- المحاوِر.. وبالتالي بمكن بناء مفاهيم كثيرة واختراع تعريفات ليست مستحيلة في إخضاع النص الأدبي الى ممكنات التصنيفات التعريفية الآخذة بالتوسع على حساب النصوص، بما نرى بأنه يُثقلها في كثير من الأحيان، ويوجهها الى منافذ نقدية قد لا تصلح كلياً الى أن تكون مشروعاً نقدياً صالحاً لبيئة النص ومرجعياته التاريخية والجمالية والثقافية الشخصية. خاصة مع اتفاقنا بأن الإبداع هو عمل عقلي، تتكفل اللغة بترجمته داخلياً، ويأخذ الشكل فيه اتجاهين؛ عبر اللغة ومستوياتها الدلالية والرمزية؛ ونرى في ضوء ذلك نجد أن ما بعد البنيوية، وما بعد الحداثة في صراعاتها مع النصوص في نظريات آيزر وبارت وتودوروف ودريدا وكريستيفا وغيرهم، استمكنت فاعلاً خارجياً، وأدخلته في ذلك الصراع عنوةً، وهو القارئ، فظهرت تصنيفاته ومسمياته، في إعادة نظرية بالنتيجة كما نحسب، ومحاولة لكتم أنفاس المؤلف، والتماهي مع الفاعل الجديد، بوصفه منتجا لا مستهلكاً، فتعددت القراءات والمفاهيم والنظريات وموت المؤلف وإحياء الناقد، وجعْل القارئ مستحوذاً على بنية النص وشكله ولونه وإلهاماته الكثيرة. لنستقرئ بالنتيجة أن المدارس والمذاهب والنظريات الأدبية خرجت من معاطف النصوص لا من معاطف القرّاء.
ولو تأملنا تاريخية النقد وتعدد قراءاته الفاعلة والوصفية والتاريخية والسيكولوجية والتأويلية والظاهراتية وغيرها سنجد أن وجود النصوص هي التي أوجدت الناقد في بديهية التفاعل والمشاركة الأدبية. وليس العكس، ومن ثم فالقارئ والناقد هما إنتاج النص وليس العكس.
نحن نتلقى النظريات والمفاهيم والأطروحات النقدية من العالم الغربي.